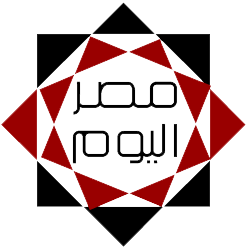إن الدول «تتفاوت» في مدى قوتها، في ظل قانون الغاب الذي يحكم معظم العلاقات الدولية. وهذا التفاوت تترتب عليه نتائج مهمة، ويختلف من وقت لآخر، ومن حالة لأخرى، سواء فيما بين دول العالم، أو بالنسبة للدولة الواحدة المعنية. وأن سلّمنا بأن العلاقات الدولية هي «صراع وسعي الدول من أجل القوة»، فإنه يترتب على هذا التفاوت في قوة الدول شيء من التفاضل.
****
ويلزم «تطبيق» هذا المدخل العلمي المبسط لمعرفة وتحديد مدى قوة أي دولة، إجراء بحث ميداني ومكتبي موسع، لـ«قياس» درجة كل عنصر من عناصر القوة الخشنة (تقريبياً) في الدولة المعنية، وكذلك عناصر القوة الناعمة، التي تتسم بها، وتمتلكها، ومحاولة معرفة مدى توفر كل من هذه العناصر فيها. وفي حالة محاولة قياس مدى قوة تكتل دولي معين، كمنظمة «جامعة الدول العربية» (مثلا) يمكن «جمع» كل قوى الدول الأعضاء (الخشنة والناعمة) في هذه المنظمة معاً، لمعرفة وتحديد مدى قوة هذا الكيان المسمى بـ«جامعة الدول العربية»، على الساحة الدولية، الذي هو الآن عبارة عن: منظمة دولية حكومية إقليمية شاملة، أو بكلمات أخرى، اتحاد «كونفدرالي» هش.
****
ومعروف أن «الاختلاف» بين الناس هو أحد سنن الكون الثابتة. كل البشر بشر، تجمع بينهم خصائص عامة مشتركة. ولكن كل منهم مختلف عن الآخر، قليلاً، أو كثيراً، وله «خصوصية» معينة. كذلك «الجماعات»، و«الدول»، و«الأمم» (الحضارات) المختلفة. فالإنسان يتجسد في عدة صور (Forms)، من أهمها: الفرد، الجماعة، الحزب، التنظيم، الدولة، الأمة... إلخ. ويتشابه سلوك كل من هذه الصور، سواء كان سياسيّاً، أو غيره، نتيجة هيمنة العنصر الإنساني في كل صورة. إن من أهم نتائج هذا «الاختلاف» هي: تنوع الحضارات واختلافها عن بعضها. كلها حضارات إنسانية.. لكن كل منها مختلف (ماديّاً ومعنويّاً وقيميّاً) عن الآخر، وله خصوصيته، كما للفرد. ومعروف، أنه ينتج غالباً عن تشابه المصالح والقيم، بين البشر (بأي صورة تجسدوا) تحاباً وتعاوناً، وعن اختلافهم تنافراً وصراعاً.
تلعب «القوة»، بمعناها الشامل، الدور الأكبر في حياة الدول. ويمكن تقسيم دور القوة في العمل، والتسلط السياسي لمرحلتين: مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية، ومرحلة ما بعدها. إن ما قاله ابن خلدون عن أصل الدولة -أي دولة- يلخص لنا دور القوة (أو «العصبية») كما ارتآه. تعني «العصبية» -في رأيه- التلاحم والمناصرة، وميل الأفراد لأقاربهم وعشائرهم، ووقوف الفرد مع أهله وأسرته، ضد من يريد إلحاق ضرر بهم.
****
ويرجع ابن خلدون قيام أي دولة إلى ضرورة العيش المشترك، التي يحتاجها الناس. فالإنسان مدني بطبعه. والدولة -في رأيه- تقوم على العصبية، ومدى قوتها. فبما أن لكل عصبية أو وحدة بشرية عزوة (قوة)، فإن هناك بالضرورة فرعاً أقوى (نسبياً) من غيره من الفروع. والرئاسة (أو الحكم) إنما تكون بالغلبة أو القوة. لذلك، فان العصبية الأقوى هي التي تسود. والرئاسة في عصبية ما، تكون -في رأيه- للفرع الأقوى من أبناء تلك العصبية. فإن ضعف، تنتقل الرئاسة للعصبية الأقوى حينها، وهكذا. ويرى أن الغاية الكبرى التي تسعى إليها العصبية الواحدة، هي الملك، أو الحكم، وتمكنها من ذلك يدعم الأمن، ويمنع الفوضى.
وقال إن الناس لا ينقادون للدولة -في رأيه- في بداية نشأتها، إلا بالقوة... ولما تستقر لها الرئاسة، ويتوالى حكامها، واحداً بعد الآخر، قد ينقاد الناس طائعين لحكومتهم، دون حاجة كبيرة، إلى قوة. وبين أن حجم الدولة ومساحتها، إنما يعتمد على حجم العصبية الحاكمة، ومدى نفوذها.
****
وهكذا، نرى أن ابن خلدون يرجع قيام النظم السياسية إلى القوة، فالعصبية الأقوى تسيطر، (وتحكم)، ويزول حكمها عندما تضعف، حيث تحل محلها عصبية أقوى، وهكذا. كما أن الدول الأقوى (أو العصبيات الأقوى) تلغي الضعيفة، وتلحقها (كأجزاء) بالدول الأقوى.
وهنا، حاول توضيح طبيعة السياسة داخل الدول. وكذلك طبيعة العلاقة (الدولية) بين القوى والأضعف، على المستوى الدولي. وقد توصل ابن خلدون لهذا الرأي من ملاحظته العلمية (الثاقبة) لما كان يجري (سياسياً) في زمنه، والزمن الذي قبله (آخر العصور القديمة، ومعظم العصور الوسطى). وكان معظم ما يجري سياسياً في ذلك الزمن، يؤيد ما ذهب إليه، خاصة في المنطقة العربية.
****
أما مرحلة ما بعد الثورة الفرنسية، فيمكن القول إن دور وتأثير «القوة» استمر كما هو منذ الأزل. ولكن معظم دول العالم الآن قد أخذت بآلية «الانتخاب»، والنيابة، لتداول السلطة سلماً، ومن وقت محدد لآخر. بدأ العالم بالنوع الأقدم الذي يستخدم القوة بالأسلوب الذي لاحظه ابن خلدون. حيث كان الديكتاتور يقدم نفسه كإله يعبد. ثم في مرحله لاحقة اعتبر المستبد «وكيلاً» من الآلهة لحكم الناس.. إلخ. وقد عانى البشر الكثير، بسب بطش واستبداد وظلم أغلب المستبدين بهم، وتكريس الحكم للمصالح الخاصة للحكام. وهنا بدأ المفكرون السياسيون في التفكير في بديل لـ«الاستبداد». فكان أن اكتشفوا «الديمقراطية» التي يعتبر البعض اكتشافها، وبلورتها فكرياً أولاً وعملياً ثانياً، مثل اكتشاف «العجلة»..!
ظهر هذا الاكتشاف السياسي في الفكر منذ حوالى 2550 سنة. وبدأ في تطبيقه فجأة في دول اليونان القديمة عام 500 ق. م – تقريباً. ثم اختفى من اليونان بعد سنوات قليلة، وزوال دول الإغريق القديمة. ولكنه استمر في الفكر والكتب، وفى أذهان وتحليلات مفكري السياسة، خاصة في عصر النهضة بأوروبا. ثم وضع موضع التنفيذ والتطبيق في القرن الثامن عشر الميلادي –من قبل الثورة الفرنسية (1789م). ومن فرنسا وبريطانيا اقتبسته أوروبا، ومن أوروبا اقتبسته بقية بلاد العالم. علماً بأن كل دولة تأخذ بجوهر هذا النوع من الحكومات، وتكيف التفاصيل بما يتلاءم وظروفها وخصائصها وأحوالها. فلا يوجد في العالم نظامان سياسيان متطابقان، أو متماثلان تماماً. وقد أصبح لـ «الناخب» قوة، يمنحها للمرشح الذي ينال استحسانه.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.