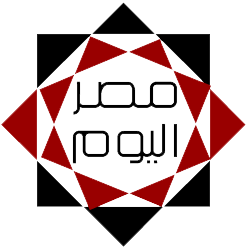في المملكة العربية السعودية، حيث تتشكل الهوية من روافد الدين والتاريخ واللغة، يصبح الحديث عن «التنازل عن الهوية» أشبه بمناقشة استئصال الجذور من شجرةٍ ضاربة في عمق الأرض.
فالهوية هنا ليست مجرد انتماء عابر، بل هي «جينات البقاء» التي تُشكِّل المناعة الحضارية للأمة ضد كل أشكال الذوبان أو التلاشي.
فكيف يصبح التفريط في هذه الهوية تفريطًا في شرط الوجود ذاته؟
تشبه الهوية الوطنية الجينات الوراثية التي تحمل شفرة الخصائص البيولوجية للكائن الحي، فهي تحمل الشفرة الثقافية والروحية لمجتمعٍ ما، وتضمن استمراره عبر الزمن.
فالهوية السعودية، المبنية على (الإسلام كدين، والعروبة كثقافة، والموروث المحلي كتاريخ)، ليست مجرد هوية «انتمائية»، بل هي عقدٌ اجتماعي غير مكتوب يربط الأجيال ببعضها، ويحمي المجتمع من أن يصير أمةً بلا ذاكرة، أو جسدًا بلا روح.
عندما تتنازل أمةٌ عن هويتها، فإنها لا تتخلى عن ماضٍ فحسب، بل تفقد بوصلة مستقبلها، لأن الهوية هي البنية التحتية للوجود الجمعي.
التاريخ البشري حافلٌ بحضارات انهارت عندما تخلت عن «جينات بقائها». الإمبراطورية الرومانية، التي أضاعت قيمها العسكرية والمدنية في بحر الترف والانفتاح غير المنضبط، تحولت إلى أسطورة.
بالمقابل، استطاعت اليابان أن تدمج الحداثة بهويتها دون أن تفقد روحها السامورائية، فحافظت على تماسكها رغم العواصف.
وفي السياق السعودي، تشكل الهوية الإسلامية العمود الفقري للنسيج الاجتماعي، فالشريعة ليست نظاماً قانونياً فحسب، بل هي الإطار الأخلاقي الذي يُنتج المعنى والقيمة، فأي تنازل عن هذا الركن يعني خلخلة النظام الاجتماعي برمته، وتحويل المجتمع إلى كيان هشٍّ قابل للاختراق.
لا يُنكر أن العولمة تفرض تحدياً وجودياً على الهويات المحلية، فهي تدفع نحو صهر الخصوصيات في بوتقة الثقافة الاستهلاكية العالمية.
لكن الخطر ليس في الانفتاح ذاته، بل في الانزياح عن الجوهر، فالهوية الحية ليست حجراً جامداً، بل هي نهرٌ متدفق يأخذ من الآخر دون أن يفقد مصدره. هنا تكمن عبقرية رؤية 2030 السعودية التي ترفض الثنائيات الزائفة (الحداثة مقابل التقاليد)، وتقدم نموذجاً لـ«هوية مرنة» تبني المستقبل دون أن تقطع الجسور مع الماضي. فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعني استبدال الهوية، بل تعني إعادة إنتاجها بلغة العصر.
إذا كانت الهوية تُكتسب بالتنشئة، فإن التعليم والإعلام هما حاضنتها الرئيسية.
فالمدرسة التي تُدرّس اللغة العربية بوصفها وعاءً للفكر، والجامعة التي تربط العلوم الحديثة بالقيم الإسلامية، ووسائل الإعلام التي تروي سيرة الأجداد بلغة الشباب، كلها أدوات لـ«تطعيم» الأجيال ضد فيروسات التغريب.
في المقابل، فإن أي تقصير في هذه المؤسسات قد يحوّل الهوية إلى مجرد «تراث متحفي»، أو أسوأ من ذلك، إلى عبءٍ يُستحى منه في ظل ضغوط الموضة الثقافية العالمية.
ليست مسألة الحفاظ على الهوية مجرد حنينٍ رومانسي إلى الماضي، بل هي استراتيجية بقاء في عالمٍ تحكمه سنن التنافس الحضاري.
فالأمم التي تذوب في غيرها تفقد سلاح المقاومة الثقافي، وتصبح تابعاً هامشياً في سردية الآخرين.
أما السعودية، التي تمتلك رصيداً هائلاً من «جينات البقاء» (الدين، اللغة، التاريخ)، فإن تحديتها تكمن في تحويل هذه الجينات إلى «كودٍ ثقافي» قادر على التكيف دون أن ينكسر.
فالهوية ليست قفصاً، بل هي جناحٌ يُحلّق به الوطن نحو آفاق المستقبل، شريطة أن يظل متجذراً في تربة أصالته.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.