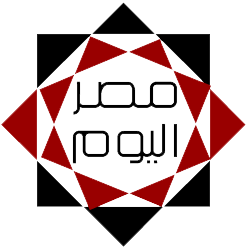صار بعض الناس يتحدّث عن الجنة كما يتحدّث عن وجهة سفر، يختار من يود أن يُحشر معه، وكأن الغيب أصبح متاحاً بالحجز المسبق، إلا تلاحظون كثرة من يرددون هذه الأيام عبارة «اللهم احشرنا مع فلان» أو «احشرني مع فلان»؟ نسمعها في المجالس، ونقرؤها في التعليقات، وتتردد على الألسنة وكأنها نوع من الولاء الإيماني أو بطاقة عبورٍ نحو الجنة. حيث تُقال بخفةٍ عجيبة، حتى يخيل إليك أن مفاتيح الجنة أصبحت تُمنح بالعاطفة، وأن مصائر الناس باتت شأناً شعبياً، يحدده المزاج لا الميزان الإلهي.
في كل مرة أسمع فيها أحدهم يدعو أن يُحشر مع شخصيةٍ أُعجب بها، أتساءل: متى تحوّل الدعاء إلى ادّعاء؟ في زمنٍ كان فيه «الحشر مع الصالحين» أمنيةً تُقال بوجلٍ وخشوع، أصبح اليوم شعاراً يُطلقه من لم يقرأ عن ذلك الرجل سوى سطرٍ في خبرٍ أو تغريدةٍ عاطفية. لم يعد الدعاء رجاءً، بل صار إعلان انتماءٍ وموقف، وكأن الإيمان تصنيف اجتماعيّ يُعبَّر عنه بالولاء للرموز لا بالتقوى.
لقد تمدّدت ظاهرة الإعجاب المقدّس حتى طغت على وعي الناس. فبدل أن يتقربوا إلى الله بالعمل، تقربوا إلى صور الأشخاص بالدعاء. وكأن الجنة في نظر هؤلاء مجمع سكنيّ فاخر يُدار بالعلاقات العامة، لا بميزان العدل الإلهي. من يعجبهم أحد يرفعونه إلى مقام الأولياء، ومن يختلفون معه يسقطونه إلى درك الفسق، وكأنهم أمناء السرّ على الغيب.
ولعلّ المدهش أن بعضهم يدعو قائلاً: «اللهم احشرني مع البخاري» وآخر يقول: «اللهم احشرني مع ابن تيمية»، وكأنه اطّلع على مصائرهم، أو أُوحي إليه بما أُخفي عن العالمين. ناسِياً أن لا أحد مبشّر بالجنة إلا عشرة بشّرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيٍ صادقٍ لا يقبل الظن. كان من الأحرى أن يدعو أن يُحشر مع أولئك الذين شهد لهم النبي، لا أن يتبرع هو بالشهادة لمن لم يُشهد له. ذلك لأن الحشر ليس رغبةً عاطفية، بل منزلة إلهية لا تُنال بالظنّ ولا تُوزّع بالمشاعر.
إن الخلط بين الولاء والدين صار علامة هذا العصر، فالكثيرون لا يفرّقون بين الحب في الله، وبين الحماسة لشخصٍ يرونه يمثل «الإيمان» أو «الحق». يتمنّون الحشر معه، لا لأنهم شاركوه العمل الصالح، بل لأنهم تشاركوا الإعجاب العاطفي. وهكذا، تحوّل الدين في منظور هذه الفئة إلى شبكةٍ من الولاءات الوجدانية، لا منظومة من القيم التي تهذب النفس وتؤصل الوعي.
ويأتي السؤال الفلسفي الأهم، متى يصبح الدعاء ادّعاءً؟ عندما يغيب عنه الخشوع، ويحضر فيه الغرور الخفيّ. حين يدعو الإنسان بما لا يعلم، ويُزكّي من لم يعرف، ويتحدث عن المصائر وكأنه يقرأ لوح القدر. ذلك هو التناقض العميق بين ظاهر الورع وباطن الجهل، بين من يدّعي الخشية وهو أسير انفعالٍ لا يعي معناه. إن الدعاء الحقيقي لا يُرفع بلسانٍ يجهل ما يقول، بل بقلبٍ يعرف أنه لا يملك من أمر الآخرة شيئاً.
تعلم أن الأسماء لا تصنع النجاة مهما لمع بريقها، ولا القرب من الرموز الدينية يمنح الإنسان رفعةً يوم الحساب. فالله يزن القلوب لا الألقاب، ويقيس الصدق لا الانفعال، ويعلم السرائر لا الشعارات. من أراد الحشر مع الصالحين، فليسر على دربهم في الصدق والتواضع والرحمة. أما من يتوسّل الجنة بالعواطف، فسينتهي به الأمر أن يكتشف أنه دعا كثيراً ولم يعمل شيئاً.
وفي النهاية، فالحشر مع الصالحين لا يُنال بالتمني، بل بالتشبه بهم في الطريق، لا بمرافقتهم في القول. أما الذين جعلوا الدعاء وسيلةً لتلميع الذوات وتجميل المواقف، فليعلموا أن الجنة لا تُفتح بالتصفيق، بل بصدقٍ لا يعرف الاستعراض، وإيمانٍ لا يحتاج جمهوراً ليصفّق له.
في كل مرة أسمع فيها أحدهم يدعو أن يُحشر مع شخصيةٍ أُعجب بها، أتساءل: متى تحوّل الدعاء إلى ادّعاء؟ في زمنٍ كان فيه «الحشر مع الصالحين» أمنيةً تُقال بوجلٍ وخشوع، أصبح اليوم شعاراً يُطلقه من لم يقرأ عن ذلك الرجل سوى سطرٍ في خبرٍ أو تغريدةٍ عاطفية. لم يعد الدعاء رجاءً، بل صار إعلان انتماءٍ وموقف، وكأن الإيمان تصنيف اجتماعيّ يُعبَّر عنه بالولاء للرموز لا بالتقوى.
لقد تمدّدت ظاهرة الإعجاب المقدّس حتى طغت على وعي الناس. فبدل أن يتقربوا إلى الله بالعمل، تقربوا إلى صور الأشخاص بالدعاء. وكأن الجنة في نظر هؤلاء مجمع سكنيّ فاخر يُدار بالعلاقات العامة، لا بميزان العدل الإلهي. من يعجبهم أحد يرفعونه إلى مقام الأولياء، ومن يختلفون معه يسقطونه إلى درك الفسق، وكأنهم أمناء السرّ على الغيب.
ولعلّ المدهش أن بعضهم يدعو قائلاً: «اللهم احشرني مع البخاري» وآخر يقول: «اللهم احشرني مع ابن تيمية»، وكأنه اطّلع على مصائرهم، أو أُوحي إليه بما أُخفي عن العالمين. ناسِياً أن لا أحد مبشّر بالجنة إلا عشرة بشّرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوحيٍ صادقٍ لا يقبل الظن. كان من الأحرى أن يدعو أن يُحشر مع أولئك الذين شهد لهم النبي، لا أن يتبرع هو بالشهادة لمن لم يُشهد له. ذلك لأن الحشر ليس رغبةً عاطفية، بل منزلة إلهية لا تُنال بالظنّ ولا تُوزّع بالمشاعر.
إن الخلط بين الولاء والدين صار علامة هذا العصر، فالكثيرون لا يفرّقون بين الحب في الله، وبين الحماسة لشخصٍ يرونه يمثل «الإيمان» أو «الحق». يتمنّون الحشر معه، لا لأنهم شاركوه العمل الصالح، بل لأنهم تشاركوا الإعجاب العاطفي. وهكذا، تحوّل الدين في منظور هذه الفئة إلى شبكةٍ من الولاءات الوجدانية، لا منظومة من القيم التي تهذب النفس وتؤصل الوعي.
ويأتي السؤال الفلسفي الأهم، متى يصبح الدعاء ادّعاءً؟ عندما يغيب عنه الخشوع، ويحضر فيه الغرور الخفيّ. حين يدعو الإنسان بما لا يعلم، ويُزكّي من لم يعرف، ويتحدث عن المصائر وكأنه يقرأ لوح القدر. ذلك هو التناقض العميق بين ظاهر الورع وباطن الجهل، بين من يدّعي الخشية وهو أسير انفعالٍ لا يعي معناه. إن الدعاء الحقيقي لا يُرفع بلسانٍ يجهل ما يقول، بل بقلبٍ يعرف أنه لا يملك من أمر الآخرة شيئاً.
تعلم أن الأسماء لا تصنع النجاة مهما لمع بريقها، ولا القرب من الرموز الدينية يمنح الإنسان رفعةً يوم الحساب. فالله يزن القلوب لا الألقاب، ويقيس الصدق لا الانفعال، ويعلم السرائر لا الشعارات. من أراد الحشر مع الصالحين، فليسر على دربهم في الصدق والتواضع والرحمة. أما من يتوسّل الجنة بالعواطف، فسينتهي به الأمر أن يكتشف أنه دعا كثيراً ولم يعمل شيئاً.
وفي النهاية، فالحشر مع الصالحين لا يُنال بالتمني، بل بالتشبه بهم في الطريق، لا بمرافقتهم في القول. أما الذين جعلوا الدعاء وسيلةً لتلميع الذوات وتجميل المواقف، فليعلموا أن الجنة لا تُفتح بالتصفيق، بل بصدقٍ لا يعرف الاستعراض، وإيمانٍ لا يحتاج جمهوراً ليصفّق له.
أخبار ذات صلة
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.