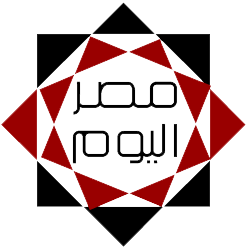الحنين هو أحد أعمق المشاعر الإنسانية وأكثرها تعقيدًا، إنه ارتباط عاطفي بالماضي، ينبثق فجأة من لحظة، أو رائحة، أو أغنية، ليعيد إلى الإنسان ذكريات قديمة كانت مدفونة في زوايا الذاكرة.
وقد كان الحنين من أبرز الموضوعات التي تناولها الشعراء على مر العصور، وقد وجد في الأدب والفن بشكل واسع فكم من قصيدة كُتبت حنينًا إلى الوطن! وكم من لحنٍ عبَّر عن شوقٍ إلى الأحبة! وقد أبدع الشعراء في تصوير هذا الشعور بألفاظ رقيقة ومعانٍ مؤثرة، فظهر الحنين في أشعار الجاهليين كجزء من الوقوف على الأطلال، حين نادى امرؤ القيس صحبهُ:
قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكرى حَبيبٍ ومَنزِلِ... بسِقْطِ اللِّوَى بينَ الدَّخولِ فَحَوْمَل
ويمتد أثر الحنين ليصل إلى الحاضر، فيصوغ وجدان الإنسان ويؤثر في قراراته ونظرته إلى الحياة. فقد يدفعه الحنين أحيانًا إلى إعادة الاتصال بأشخاص انقطعت بهم السبل، أو إلى زيارة أماكن كانت جزءًا من ذاكرته، أو حتى إلى محاكاة ماضٍ رحل عبر صور، أو كتابات، أو طقوس بسيطة.
لكن هذا الشعور، رغم جماله، قد يحمل في طياته شيئًا من الألم؛ لأنه يعيدنا إلى ما لا يمكن استعادته. فهو يُشعر الإنسان بنوع من الفراغ، وبفقدٍ دائم لا يُعوّض، لا لأنه كان الأفضل، بل لأنه أصبح بعيدًا، ومُحاطًا بهالة من المشاعر التي صنعها الزمن. وقد يتحوّل هذا الحنين إلى دافع للإبداع، أو إلى حافزٍ للتغيير، وأحيانًا، إلى حزنٍ عميق إذا لم يُحسن الإنسان التعامل معه.
الحنين ليس ضعفًا، بل تعبير عن إنسانيتنا العميقة، عن قدرتنا على التعلّق، وعلى المحبة، وعلى التقدير. هو اعتراف ضمني بأننا لسنا مجرد حاضِرٍ عابر، بل كيانٌ تُشكّله طبقات من الذكريات، والأماكن، والأشخاص، والتجارب.
وفي هذه الفترة تحديدًا، يراودني حنين عميق لا يمكن تجاهله، حنين يأخذني إلى أيام الطفولة التي قضيتها في كنف جدي وجدتي – رحمهم الله –. لقد نشأت بين أيديهما، في ذلك البيت الذي لم يكن مجرد مكان للسكن، بل كان موطنًا حقيقيًا للطمأنينة والحب.
كنت الحفيدة الأولى، وهذا وحده كان كافيًا لتكون لي مكانة خاصة في قلوبهم. عشت الدلال بكل تفاصيله، كنت أُستقبل بفرح لا يُوصف، وكنت أرى السعادة تكسو ملامحهم في كل مرة نأتي فيها لزيارتهم. كم أفتقد تلك الضحكات الصادقة، ودفء المعاملة، وحنان الجدّين اللذين لم يبخلا عليّ يومًا بشيء.
في بيت جدي لعبت، وضحكت، بكيت وتعلمت. هناك، تشكّلت أجمل ذكرياتي، وهناك عرفت أولى معاني الحُب الحقيقي والعطاء النقي. واليوم، وقد غابوا عن الدنيا منذ سنوات، أشعر بفراغ لا يمكن للكلمات أن تعبّر عنه، شعرت فيه بمعنى الفقد. إن وجودهم في الحياة كان نعمة تُضيء القلب، لكنّ بعض النِعم لا نُدرك قيمتها إلا حين تُسلب، وقد يضيع من بين أيدينا قلبٌ أحبّنا بصدق، فنفيق على غيابه بعد أن فات الأوان، نلهث خلف الذكرى، ويُعلمنا الغياب أن الحب لا يموت، بل يتجلّى في الحنين.
أشعر بالغِبطة حين أرى الناس بصحبة جداتهم؛ أراقبهم بشوق لا يُوصف، وكأنني أبحث من خلالهم عن لحظة تعيد لي جدتي، تعيد لي الشعور. أشتاق للحديث معها، لمساعدتها، وللجلوس إلى مائدة الطعام بجانبها. أريد جدتي... أريد أن أعيش معها من جديد ولو لوهلة، أن أسمع صوتها، أن ألمح ابتسامتها التي كانت تبعث في قلبي طمأنينة لا مثيل لها.
أما الآن، حين أدخل منزلهم، ذاك المكان الذي كان يعجّ بالحياة، أشعر بأنه لم يعد حيا، بل تحول إلى مكان مهجور، موحش، يقشعر بدني كلما خطوت إليه. لم يعد موطنًا، لأن من كانوا يحيونه قد غابوا. وفي تلك اللحظة، تردّد في ذهني بيت من الشعر كأنّه قيل عنهم:
«كنت أحسب عمار الدار يا سعود جدران.. وأثر عمار الدار يا سعود أهلها»
نعم، ما كان يُعطي ذلك البيت حياته، لم يكن الجدران ولا الأثاث، بل هم.. أهل الدار، جدي وجدتي، رحمهم الله.
وأنا، «حنين» لم أكن أفهم معنى اسمي كما أفهمه الآن. كنت أظنه مجرد حروف جميلة، حتى عشته بكل تفاصيله المؤلمة بعد فقدكما. أصبحتُ الحنين ذاته، أعيشه كلما مرّ طيفكما في الذاكرة، كلما دخلتُ ذلك البيت الذي كان يومًا ملاذي، كلما رأيتُ جدةً تُمسك بيد حفيدتها، أو جدًا يربّت على كتف حفيده.
رحمكما الله بقدر ما أحببتكما، وبقدر ما افتقدتكما، وبقدر ما أشتاق!
حنين، ذلك الشعور الذي لا يهدأ،
أعيش بين ضلوعي شوقًا لا ينطفئ، صوتي هو همسات الماضي التي لا تنسى، وألمي هو فقدٌ لا يُشفى.
في كل لحظة، أنا أبحث عن مكانٍ يعود بي إلى دفء الذكريات.
[email protected]
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.