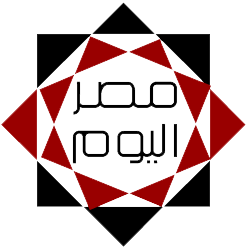في مثل هذا اليوم من كل عام، يعود اسم يوسف شاهين إلى الواجهة، لا بوصفه مجرد مخرج سينمائي، بل باعتباره ضميرًا فنيًا حيًا لا يخبو صوته، وصاحب مشروع سينمائي فكري طالما أرّق الواقع المصري، وأشعل النقاش حول حدود الفن، ووظيفة السينما، وعلاقة الفنان بمحيطه.
لم يكن هدفه فقط تقديم الحكايات، بل تحريك المياه الراكدة في المشهد الثقافي، وتشريح العلاقة المتشابكة بين الفرد والمجتمع، والتاريخ والهوية. أفلامه لا تُشاهد فقط، بل تُقرأ وتُناقش وتُعاد مشاهدتها كلما تغيّرت الأسئلة أو تبدلت الأزمنة.
هو من أولئك القلائل الذين لا يمكن اختزالهم في لقب "مخرج كبير"، لأن أعماله تتجاوز الحرفة إلى الموقف، والعدسة عنده ليست أداة جمالية بقدر ما هي وسيلة مقاومة، يُسلّط بها الضوء على المسكوت عنه، ويُدين بها القمع والتكرار والخذلان، سواء في السياسة أو الفن أو الحياة نفسها.
البداية في الإسكندرية
ولد شاهين في الإسكندرية عام 1926، وظلت مدينته الأولى حاضرة في روحه كما في كثير من أفلامه، بوصفها مكانًا للتمازج الثقافي والانفتاح، لا الانغلاق والانعزال.
نشأ في بيئة سكندرية، متعدّدة الوجوه والانتماءات، وسط شوارع ناطقة بلغات مختلفة، ومذاهب متنوعة، وثقافات تتلاقى وتتقاطع. تلك النشأة المبكرة زرعت فيه ولعًا بالتنوع، ورفضًا غريزيًا لأي محاولة لفرض هوية واحدة أو فكر واحد. الإسكندرية لم تكن عنده مجرد خلفية بصرية، بل حالة ذهنية. ظهرت كرمز للحريات المسلوبة في "إسكندرية...ليه؟"، وكخزان لذاكرة متشابكة في "إسكندرية كمان وكمان"، حتى أنه قال عنها مرة: "الإسكندرية هي أنا... البحر ده اللي بيكلمك فجأة... الغموض ده اللي جوّه كل حاجة."
درس في الولايات المتحدة، لكن لم تجذبه هوليود
ذهب يوسف شاهين إلى معهد باسادينا في كاليفورنيا، حيث تلقى دراسة سينمائية كلاسيكية، وتعرّف إلى أساليب السرد الغربية، لكنه لم ينخرط في نمط السينما التجارية الهوليودية. عاد إلى مصر وفي جعبته وعي سينمائي مبكر، وإحساس متجذر بالانتماء إلى هذا الشرق المتعب، المقهور، والمتمرد أيضًا، كان عائدًا لا لينسجم، بل ليزعج.
أسس منذ باكورته "بابا أمين" (1950)، ثم "ابن النيل" (1951)، ما صار يُعرف لاحقًا بـ "السينما المؤلفة"؛ سينما المخرج الذي يقول شيئًا لا فقط يصنع صورة.
في "ابن النيل"، وضع أولى لبنات مشروعه الواقعي، عبر قصة شاب قروي يبحث عن نفسه بين قسوة الريف وضياع المدينة، فمزج التوثيق بالحكاية، والواقعية بالنزعة الإنسانية. لم تكن "السينما المؤلفة" شعارًا، بل التزامًا طويل الأمد: الكاميرا عند شاهين لا تُدار بطلب المنتج، بل بإلحاح الأسئلة.
من الواقعية إلى التأمل في الذات
لم يكن يوسف شاهين مخرجًا يكرر نفسه، بل فنانًا يطارد أسئلته، حتى لو أخذته إلى طرق وعرة. بدأ من الواقعية الاجتماعية والاقتصادية، كما في "ابن النيل" و"صراع في الوادي"، لكنه سرعان ما تجاوزها إلى الواقعية النقدية، ثم إلى سينما التأمل في الذات والتاريخ والمصير.
في "باب الحديد" (1958)، أحدث صدمة داخل المشهد السينمائي المصري: لم يكتف بإخراج الفيلم، بل أدى فيه دور "قناوي"، البائع المعاق نفسيًا، المهووس والمرفوض اجتماعيًا، في معالجة نفسية شديدة الجرأة. هذا الفيلم – الذي رُفض شعبيًا في البداية – أصبح لاحقًا حجر زاوية في تاريخ السينما العربية. قال عنه شاهين: "كنت عايز أقول إن الجنون مش بعيد عن أي حد فينا... وإن المهمش مش لازم يكون غبي أو شرير."
مع "الاختيار" (1971) دخل إلى عوالم أكثر تعقيدًا في البناء الدرامي، وبدأ يمزج الشخصي بالعام، والواقعي بالرمزي. لكن التحول الكبير جاء مع "إسكندرية... ليه؟" (1978)، حين قرر أن يروي سيرته الذاتية، ولكن عبر المرآة المزدوجة: الطفل الذي يشاهد الحرب والاحتلال والحب والمسرح، والمخرج الذي يتأمل كل ذلك من مسافة زمنية وفكرية.
لم يكن التأمل في الذات عند شاهين هروبًا من الواقع، بل وسيلة لاكتشاف علاقة الذات بالمجتمع، بالغرب، بالتاريخ، بالسينما نفسها. سأل في "حدوتة مصرية": "أنا اخترت؟ ولا اتفرض عليا أكون كده؟"
وهذا التوتر بين الإرادة والمصير ظل يتردد في معظم أفلامه، كما ظل الشك والبحث سمتين أساسيتين في مشروعه الفني. لم يكن يريد أن يشرح الواقع فقط، بل أن يهزه، ويقلقنا منه.
في "العصفور" (1972)، كان شاهين من أوائل من تناولوا هزيمة يونيو 67 من منظور داخلي – لا كخيانة خارجية، بل كنتيجة لانهيار داخلي. لم يخشَ الإشارة إلى الفساد السياسي، وقدم المواطن العادي، موظف البريد، كمفتاح لفهم الانهيار. قال في أحد اللقاءات: "الناس كانت عايزة أفلام بطولات، وأنا شايف إن أول خطوة للبطولة إنك تعترف بالهزيمة."
ولم يكن يخشى أن يظهر هو نفسه مادة للنقد والتشريح، كما فعل في الثلاثية: "إسكندرية... ليه؟"، "حدوتة مصرية"، و"إسكندرية كمان وكمان". هناك، صنع من نفسه شخصية على الشاشة، بصوته وصورته واسمه، يعترف، يتهكم، يثور، ويضحك على تناقضاته. لم يقدم نفسه كبطل، بل كإنسان يبحث عن إجابات، ويخطئ مثل الجميع.
وقد لخّص ذات مرة فلسفته تلك بقوله: "أنا مش عايز أقول للناس إيه الصح، أنا عايزهم يسألوا معايا: هو إحنا ليه بقينا كده؟"
بين الممثلين والنقاد: حب وتوتر واحترام
لم تكن علاقة يوسف شاهين بالممثلين علاقة تقليدية بين مخرج وفنانين؛ كانت أشبه بسيرك ناري من التجريب والانفعالات، حيث يبحث عن الطاقة الخام، لا الأداء المصقول. كان يفتّش عن “الشرارة” الخفية داخل كل ممثل، ثم يشعلها حتى النهاية، حتى لو احترق الطرفان في الطريق.
في إحدى المقابلات، وصفته يسرا بأنه "أكثر من مخرج.. كان مدرسة في الحياة. يزعق ويحضن في نفس اللحظة". هذا التوتر العاطفي الذي ميّز شخصيته انعكس تمامًا على أفلامه: أفلام لا تهدأ، تنبض بالأسئلة، وتمتلئ بالصراخ والضحك والبكاء.
لم يكن يؤمن بـ"التوجيه الناعم". يقول الممثل خالد النبوي: "العمل مع شاهين كان أشبه بالوقوف عاريًا أمام مرآة ضخمة، يراك كما أنت، ويطلب منك أن تكون أكثر."
ولم يكن هذا الهوس بالتفاصيل عبثيًا، بل هو ما جعل ممثلين كثرين ينفجرون في أفلامه. عمر الشريف نفسه، الذي انطلق عالميًا، لم ينسَ أبدًا أن شاهين هو من اكتشفه، ومنحه أول بطولة سينمائية في "صراع في الوادي" (1954). وقد قال الشريف: "يوسف علّمني كيف أكون ممثلًا حقيقيًا... كيف أكون إنسانًا أمام الكاميرا، لا مجرد نجم."
أما مع النقاد، فكانت العلاقة أشد تقلبًا. لم يكن شاهين يستجدي المديح، ولم يتردد في الردّ على من يراه متحاملًا أو ضيق الأفق. بعض النقاد رأوا في أفلامه تمركزًا حول الذات، وغموضًا مفرطًا، لكنه كان يردّ دائمًا بابتسامة حادة: "الغموض؟ هو أنتم مش عايزين تتعبوا في الفهم؟ السينما لازم تشغّل دماغنا، مش بس عيننا."
وفي "إسكندرية كمان وكمان"، يضع ناقدًا سينمائيًا كشخصية في الفيلم، يتهمه بالتكرار والنرجسية، فيجيبه شاهين على لسان شخصيته: "أنا بكرّر؟ يمكن علشان الواقع نفسه بيتكرر، وأنا مش قادر أهرب من الوجع ده."
وكان الناقد الكبير سمير فريد من أبرز من قرأوا مشروع شاهين بعمق. كتب مرة: "في سينما شاهين، لا توجد راحة، بل نزاع دائم بين الجمال والشك، بين الحلم والخذلان. إنه مخرج يُرهقك، لكنه لا يخذلك."
ربما لهذا، لم يكن شاهين محبوبًا دائمًا، لكنه كان حاضرًا بقوة في كل من اشتغل معه أو كتب عنه؛ علامة استفهام دائمة، لا يمكن المرور عليها مرور الكرام.
يمكنكم قراءة: طلب غير متوقع من الراحل يوسف شاهين لـ نيللي كريم.. تعرفوا إليه
بين التكريم والتجاهل
رغم مكانته كأحد أبرز مخرجي العالم العربي، لم يكن يوسف شاهين يومًا ابنًا مدللًا للسلطة، ولا نجمًا في أعين التيارات المحافظة، فظل يتأرجح بين التكريم الدولي والتجاهل المحلي. كان وجوده نفسه يمثل تحديًا، ليس فقط بما يطرحه من أفكار، بل بطريقة حضوره، وصوته العالي، وإصراره على أن "الفن موقف، لا مهادنة فيه".
في الخارج، حظيت أفلامه بتقدير واسع. شارك في مهرجان كان أكثر من مرة، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى عن فيلمه "وداعًا بونابرت" (1985)، وهو عمل جريء يعيد النظر في لحظة تاريخية حساسة: حملة نابليون على مصر. لكن اهتمامه لم يكن منصبًا على "الأوسكار" ولا "الريد كاربت". قال ذات مرة: "أنا مش بهتم أوي بالجوائز، بهتم أكتر باللي بيتفرج على الفيلم ويحس بحاجة جوه قلبه."
أوروبا احترمت مشروعه السينمائي المختلف، واعتبرته بعض المؤسسات النقدية الفرنسية "فيلسوف الشاشة العربية". بل إن معهد العالم العربي في باريس كرّمه أكثر من مرة، وعرض أفلامه ضمن تظاهرات كبرى. في المقابل، ظلّ شاهين في مصر يواجه صدامًا مع الرقابة، خاصة في أفلام مثل "المهاجر" و"الآخر"، التي اعتبرتها بعض الجهات الرسمية والدينية "مسيئة" أو "تثير الفتنة".
كان شاهين يدرك هذا التناقض، لكنه لم يساوم. يقول في حوار تلفزيوني نادر: "أهم وسام خدتُه مش من دولة، خدتُه من واحد خرج من السينما وقالي: أنا شفت نفسي في فيلمك."
حتى في لحظة تكريمه الكبرى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عام 2001، لم تفارق السخرية لسانه. قال مازحًا على المسرح: "أخيرًا افتكرتوني! بس يلا، أحسن من مافيش." وضجت القاعة بالضحك، بينما كان هو يعلم تمامًا أن تكريمه كان دائمًا مسألة إرباك لبعض المؤسسات، لا احتفاءً خالصًا.
قال عنه المخرج الراحل رضوان الكاشف: "كان صوتًا يزعج الرقابة، ويوقظ الجمهور، ويربك السينمائيين. كان في موقعه الصحيح: في قلب العاصفة."
الإرث الحي
حين رحل يوسف شاهين في 27 يوليو 2008، بدا وكأن السينما العربية فقدت آخر فرسانها الكبار. لكن الحقيقة أن "جو"، كما كان يُلقّب، لم يرحل حقًا. لقد ترك ما هو أكثر من أفلام. ترك مفردة سينمائية كاملة تحمل اسمه، وأسلوبًا في الرؤية، ونهجًا في الصدام، وموقفًا لا يزال يلهم أجيالًا من صناع السينما الذين جاؤوا بعده.
لم يكن شاهين مجرد مخرج يُشاهد ويُدرّس، بل مدرسة حقيقية في التعبير الحر. أفلامه اليوم تُعرض في أكاديميات السينما في أوروبا وأمريكا كأمثلة على سينما الجنوب العالمي، الرافضة للتبعية، المتحدّثة بلغتها، والمشتبكة مع قضاياها. وتُدرّس أفلام مثل "عودة الابن الضال"، "العصفور"، و"حدوتة مصرية" بوصفها نصوصًا بصرية قادرة على التقاطع مع علم النفس، والتاريخ، والدراسات ما بعد الكولونيالية.
ترك شاهين وراءه شركة "مصر العالمية"، التي أصبحت بعد وفاته منصةً لتوزيع أرشيفه وترميم أعماله، بجهود ورثة روحية ومهنية، في مقدمتهم المخرج خالد يوسف، الذي كان من أقرب تلامذته، وتعاون معه في مراحل متقدمة. كما نشأت تيارات سينمائية كاملة مستلهمة من "أسلوب شاهين"، في المزج بين السياسي والشخصي، وبين التأمل الذاتي والاشتباك مع الواقع.
حتى اليوم، يتوقف النقاد عند أفلامه ليُعيدوا قراءتها من زوايا جديدة. في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2023، عُرضت نسخة مرمّمة من فيلم "إسكندرية ليه؟" وسط حضور جماهيري غير متوقّع، وهتافات شبابية بعد العرض: "جو ما ماتش". بدا أن الأجيال الجديدة، رغم اختلاف الزمان والوسائط، وجدت في أفلام شاهين تعبيرًا عن قلقها، وتوقها للحقيقة، وعن رفضها للجاهز والمقولب.
وقد يكون أعظم إرث تركه شاهين، أنه لم يكن يدّعي امتلاك الحقيقة. بل حرّضنا جميعًا على الشك، على البحث، على إعادة طرح الأسئلة. في إحدى حواراته الأخيرة قال: "اللي بيخاف من الحقيقة، ما يعملش سينما. يعمل إعلانات!"
واليوم، لا تزال هذه الجملة تصلح أن تكون دليلا لكل سينمائي يحلم بكسر القيود، لا الخضوع لها.
أفلام لا تُنسى: بانوراما من مسيرة يوسف شاهين
على امتداد أكثر من خمسة عقود، أنجز يوسف شاهين ما يزيد عن أربعين فيلمًا، شكّلت معًا مرآة لتطور رؤيته وتقلّب أسئلته. من أفلامه الأولى التي مزجت بين الحس الشعبي والنبرة السياسية مثل "ابن النيل" (1951) و،"صراع في الوادي" (1954)، إلى تحفته الواقعية "الأرض" (1970)، التي تعدّ من أبرز أفلام الريف في السينما العربية، ومرورًا بـ"العصفور" (1972)، الذي شخّص لحظة الانكسار القومي بعد نكسة 67.
في سبعينياته أيضًا، جاءت "عودة الابن الضال" (1976) و،"إسكندرية... ليه؟" (1978)، كبداية لسلسلة أفلام ذاتية، أكملها بـ،"حدوتة مصرية" (1982)، و،"إسكندرية كمان وكمان" (1990)، و،"إسكندرية...نيويورك" (2004)،، حيث أصبح "جو" الشخصية والراوي والمخرج، في مزيج نادر من الاعتراف الفني والتأمل الشخصي.
كما خاض تجارب مثيرة للجدل، مثل "المهاجر" (1994) والآخر" (1999)، الذي تناول فيه صراع الحضارات والهُوية، وأخيرًا "هي فوضى" (2007)، الفيلم الذي شارك في إخراجه مع خالد يوسف، وقرأه كثيرون كتمهيد سينمائي مبكر لغضب قادم.
كل فيلم كان نافذة على عالم شاهين، لكنه لم يكرر نفسه أبدًا. ظلّ يبحث، يتحدى، ويغامر، حتى المشهد الأخير.
يوسف شاهين.. السينمائي الذي لم يمت
لم يكن يوسف شاهين مجرد اسم يُضاف إلى سجل عظماء السينما، بل كان - ولا يزال - سؤالًا مفتوحًا. سؤال عن الحرية، عن الإيمان، عن الجسد والروح، عن الوطن والمنفى، عن الإنسان في أكثر حالاته صدقًا وتهشيمًا. سينماه لم تكن راحة ولا تسلية، بل صراعًا مستمرًا مع الذات والآخر، مع الرقابة، مع الجمهور وحتى مع الكاميرا ذاتها.
كان جو مخرجًا يرى العالم من خلال عدسة قلقه، لا من عدسة الرضا. لا يهادن، لا يكرر إلا ليكشف تكرار الواقع، ولا يسرد إلا ما يوجعه ويحرّضه. وقد دفع ثمن هذا الطريق الشائك، عزلة أحيانًا، وحروبًا نقدية أحيانًا أخرى، لكنه بقي، رغم كل شيء، مرآة لزمنه وصوتًا لما لا يُقال.
في زمن تُقاس فيه القيمة بعدد المشاهدات والإعجابات، تظل أفلام شاهين عصيّة على الاستهلاك السريع. تتطلب منك أن تتوقف، أن تفكّر، أن تواجه نفسك. وفي هذا، يكمن سحره الحقيقي. إنه المخرج الذي لا ينتهي فيلمه عند التترات، بل يبدأ بعده في عقل المشاهد وقلبه.
بعد سبعة عشر عامًا على رحيله، لا تزال أفلام يوسف شاهين تُعرض وتُناقش وتُثير الجدل. وهذا وحده كفيل بأن يجعلنا نُدرك أنه لم يرحل فعلًا. لقد غاب الجسد، وبقي الصوت.
صوت السينما الحرة، وصوتنا نحن، حين نقرر أن نحلم ونفكر ونتكلم، كما فعل هو، دون خوف.
يمكنك قراءة.. فيلم"بنات ألفة" يحصد 3 جوائز بمهرجان كان في دورته الـ 76
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سيدتى ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سيدتى ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.