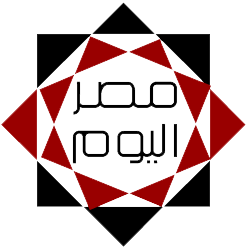أتاحت لي إعادة قراءة كتاب «شيطان النظرية – الأدب والحس المشترك»، أحد الأسفار النفيسة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن الماضي ١٩٩٨ في حقل نظرية الأدب. مؤلفه هو الناقد الفرنسي أنطوان كومبانيون «١٩٥٠- ....» أحد أنشط نقاد الأدب ودارسيه في فرنسا». العودة مجددا للاهتمام بقراءة تاريخ النظرية الأدبية والمسارات التي اتخذتها داخل الحقول المعرفية والفلسفية الغربية.
لكنها عودة لا تتصل بالكتاب نفسه فقط، وما أثاره من جدل فكري وأدبي في أوروبا وأمريكا، ولا تتصل هذه العودة أيضا في الاهتمام بترحل النظرية وتلقيها عند النقاد العرب التي احتلت مساحة كبيرة من إنجازهم النقدي واجتهاداتهم النقدية حول النص، إنما تتصل عندي بالسؤال الذي ظل يلح عليّ ويرافقني أثناء هذا السفر، هو ما الدوافع التي تعزز من ظهور نظريات تسائل من خلالها طبيعة الأدب وتصوراته وتصيغ مفاهيم له وتحدد ووظائفه وموقعه الاجتماعي والتاريخي؟
بينما يصعب – بالمقارنة – انبثاق مثل هذه الدوافع في ثقافة أخرى بحيث تكون رافعة في وجود نظريات بهذا الحجم من التراكم في النظريات والحقول المعرفية المتصلة بها ، وأنا أعني هنا الثقافة العربية المعاصرة.
لكن قبل حصر هذه الدوافع حسب استقرائي في ثلاثة ، سأتناول في الحديث أبسط التعاريف المتداولة عن النظرية الأدبية التي هي مجموعة من الأفكار والمفاهيم المستمدة من مرجعيات معرفية وفلسفية ندرس من خلالها النصوص الإبداعية المختلفة ونحللها ، بحيث كل نظرية من النظريات تعطي نتائجها حسب المنهج والمرجع الذي تأتي منه، فإذا كان المرجع التحليل النفسي فالوظيفة التي تعطى للأدب هنا هو سبر أغوار النفس البشرية ضمن نظرية التحليل النفسي للأدب، وإذا كان المرجع اللغة باعتبارها عصب الإنتاج الأدبي ومحوريته فإن وظيفته الجمالية ترتبط بمفاهيم النظرية البنيوية «كالبنية والحقل الدلالي والصوتي والإيقاعي ..ألخ» التي تعلي من شأن اللغة على حساب المؤلف والتاريخ والسياق الخارجي. أما إذا كان الأدب صورة للواقع الاجتماعي والأقتصادي فإن المرجع هي النظرية الاجتماعية الماركسية للأدب التي ترى الأدب انعكاسا لمؤثرات اجتماعية واقتصادية، أما إذا كان الاهتمام ينطلق من تشكلات صورة الأدب في أذهان المجتمع وكيف يتم التعامل معه وفق هذه التشكلات، وبالتالي طرق تأويله والقواعد المرتبطة بهذا التأويل، فإن مرجع هذا التوجه هو نظرية التأويل «الهيرمينوطيقيا» بحيث يختص كل دافع فيها بمسار له ارتباط وثيق بالتاريخ الأوربي في خصائصه الفكرية والفلسفية والاجتماعية والسياسية.
الأول منها يتصل بمسار تطور المعرفة العلمية منذ القرن الثامن عشر وطموح المعارف الأخرى الإنسانية والأدبية والاجتماعية باللحاق بها والتأثر بأفكارها ومنجزاتها للوصول إلى المعرفة العلمية في الدراسات الاجتماعية والأدبية، بينما الدافع الثاني يتصل بالمركزية الغربية التي وجدت في النظرية المعرفية سلطة مهيمنة على ثقافات العالم بغض النظر عن قيمة النظرية المنتجة من هذا الحقل المعرفي أو ذاك وأثرها على الثقافة المعاصرة.
أما الدافع الثالث قائم على حركية الثقافة الأوروبية وعدم ركونها للسكون، فمنذ أن تأسست النظرية النقدية على فكر وأقطاب فلاسفة كبار بدءا من أيمانويل كانت مرورا بهيجل وانتهاء عند نيتشه وهيدجر ومدرسة فرانكفورت والتقاليد الثقافية للنظرية في جميع أنحاء أوروبا له وقع السلطة المهيمنة.
لذلك، لا غرابة حين يحتد الصراع بين توجهات مختلفة داخل النظرية الواحدة وبين ما يجاورها من نظريات في حقول مختلفة من العلوم الإنسانية.
خلاصة ما نريد قوله، أن الوعي بتاريخ النظرية الأدبية وتحولات مساراتها يجعلنا أكثر اقتناعا أن النص والعالم يقول لنا أكثر مما تقوله النظرية.
[email protected]
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.