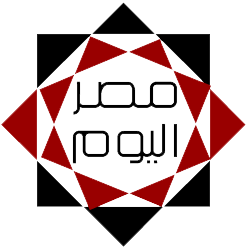خليفة بن حامد الطنيجي
هنا نروي حكايةً وُلدت قبل 125 عاماً، لأشخاصٍ عاشوا على هذه الأرض الطيبة، فخلّدوا أسماءهم بما قدّموه من تجاربٍ وصبرٍ وعملٍ صادق.
وبعطائهم صاغوا عِقداً متيناً من القيم، لا ينفصم من مسيرة هذا الوطن، وأسّسوا لبناته الأولى التي قامت عليها حكاية من العطاء والتضحيات.
بداية الحكاية عندما وُلد جدّي حامد بن عبيد الطنيجي، قرابة عام 1900، في فترة تاريخية مهمة من تاريخ إمارات الساحل المتصالح. وتزامن ذلك العام مع قيام الشيخ صقر بن خالد القاسمي بتوحيد إمارة القواسم تحت رايته في الشارقة ورأس الخيمة، وهو حدث سياسي بارز كان له أثرٌ مباشر في استقرار الأوضاع العامة، وانعكاسات واضحة على البنية الاجتماعية والواقع المعيشي في المنطقة آنذاك.
نشأ حامد الطنيجي، رحمه الله، في بيئة بدوية أصيلة في منطقة الذيد، وترعرع في كنف والده عبيد بن عبيد بن خليف الطنيجي، وتشكّلت شخصيته على قيم الصحراء من صبرٍ وجلَدٍ واعتمادٍ على النفس. وكان لجدّي عدد من الأشقاء، هم: مطر بن عبيد، راشد بن عبيد، وخليفة بن عبيد، وسعيد بن عبيد، وله شقيقة هي عائشة بنت عبيد، إضافة إلى أخ وأختين غير أشقاء هم سالم بن عبيد وشيخة بنت عبيد وموزة بنت عبيد.
في طفولته وشبابه، عاش الجد حياة الترحال والتنقّل، متنقّلاً على ظهور المطايا كان لديه ناقة «ليتيمه» وبعير «الخوار»، تأثر بتجربة والده الذي ذاق مرارة اليُتم مبكراً، فغدا مثالاً في تحمّل المسؤولية والكفاح. وانعكس ذلك على نمط حياته، إذ اعتمد على نفسه في كسب الرزق، وأسهم في إعالة أسرته وتربيتها، في ظل رزقٍ شحيح، لا يتجاوز التمر وبعض ما تجود به الأسواق القديمة..
ترحال
كان جدّي حامد يرافق والده عبيد في رحلات الترحال بحثاً عن الرزق، متنقّلاً بين عدد من المناطق بحسب الحاجة وتوفّر المياه. بين واحة النخيل بالذيد وحصن طنيج إلى وادي السيجي، حيث كانت للأسرة مزارع تقيم فيها فترات متفاوتة، تشارك في رعاية النخيل والأشجار المثمرة، وتتابع شؤون الزراعة والسقيا، وكانت مدة الإقامة تطول أو تقصر تبعاً للظروف البيئية والموسمية.
كما كان ينتقل إلى منطقة سهيلة، حيث يقيم «خواله» من الحوافر لأمه (نهيله)، فيمكث عندهم بعض الوقت، ويشاركهم مجالسهم اليومية التي كانت عامرة بالأحاديث والمعرفة والدراية، ويتداول فيها الشعر والسير، وتقام خلالها مسابقات الرماية على «الشبح»، وهي من الفنون والمهارات المتداولة آنذاك، وتُعد مظهراً من مظاهر التدريب على الفروسية والدفاع.
كما كانت تنقّلاتهم تمتدّ من طويٍ إلى آخر، من طوي سهيلة إلى الزبيدة، مروراً بطوي مرقبات العتيدة، ثم إلى الحليوة، وصولاً إلى مهذب وتاهل.
وأسهمت هذه التنقّلات المبكرة في صقل شخصية جدّي، وإكسابه خبرات متنوعة في شؤون القبائل والعيش في البادية، إلى جانب ما نهله من المجالس من حكمة ومعرفة، ما انعكس لاحقاً على سلوكه ونمط حياته وعلاقاته الاجتماعية.
عندما شبّ جدّي حامد بن عبيد بن خليفة الطنيجي وبلغ مقتبل العمر، تزوّج بجدّتي ميثاء بنت سيف بن عليّ الطنيجي، وأسّسا معاً أسرةً في ظروفٍ معيشية اتّسمت ببساطة الإمكانات ومحدودية الخدمات الصحية آنذاك.
محن
رزق جدّي حامد بعدد من الأبناء، هم: مبارك بن حامد الذي توفّي صغيراً، ووالدي سيف بن حامد، وعبيد بن حامد، إضافة إلى زهو بنت حامد التي توفيت عندما بلغت العاشرة من العمر. وجاء هذا الفراق نتيجةً لمحدودية الرعاية الصحية وندرة وسائل العلاج المتاحة آنذاك، وهو أمرٌ كان شائعاً في معظم مناطق إمارات الساحل في تلك الفترة.
وخلّفت هذه الشدائد أثراً بالغاً في نفسيّة جدّي حامد وجدتي ميثا، إذ شكّل فقد فلذات أكبادهما فراقاً قاسياً ترك بصمته العميقة في حياتهما، وعزّز لديهما معاني الصبر والاحتساب والتماسك الأسري في مواجهة تلك المحن.
وعندما رزقا بعمي عبيد، آخر العنقود، بقيت جدّتي إلى جواره ترعاه بمحبة وحنان، غير أنّها لم يمهلها المرض الذي المّ بها، فانتقلت إلى جوار ربها، في مشهدٍ خيّم الحزن العميق على الأسرة والقبيلة لفترة طويلة. ترك رحيلها أثراً بالغاً في قلب جدّي، الذي ظل مكلوماً بفقدان زوجته، بعد أن فقد اثنين من أبنائه. وكان هذا الفصل من حياته مليئاً بالآلام والابتلاءات، لكنه أيضاً رسّخ في الأسرة قيم الصبر والجلد على قسوة الحياة.
يروي والدي سيف موقفاً إنسانياً خالصاً عن جدّي حامد بن عبيد الطنيجي، تتجلّى فيه أبوةٌ عميقة يمتزج فيها الخوف بالفقد، ففي عام 1967، وأثناء التحاق والدي بالخدمة العسكرية في معسكر المنامة، ألمّ به المرض خلال فترة التدريب، وما إن بلغ الخبر جدّي حتى جمع ما يعرفه من أدوية عشبية، ومضى إليه بقلقٍ لا يعرف الانتظار.
قطع المسافة من الذيد إلى المعسكر، نحو 20 كيلومتراً، مشياً على قدميه، منهك الجسد، مثقَل القلب، لا يحمل سوى رجاء أبٍ يخشى أن يُفجع بابنٍ آخر. وعند أسوار المعسكر، كان يبحث عن ابنه بوجهٍ أكل منه الإعياء، ويدين ترتجفان وهما تمسكان بالأدوية، في مشهدٍ استوقف أحد الضباط قبل أن يدرك بساطة الرجل، وعدم إلمامه بوجود الرعاية الطبية داخل المعسكر.
وحين أبصر جدّي حامد ابنه سيف، انهار ثقل الطريق في صدره، فاحتضنه باكياً، وانهمرت دموعه على لحيته وهو يطمئن إلى أنه ما زال حياً بين يديه. كان ذلك اللقاء جرحاً مفتوحاً وبلسماً في آنٍ واحد، خوف أبٍ أنهكه فقد ابنين ورفيقة دربه، فصار قلبه لا يحتمل الغياب، ولا يعرف السكينة إلا عند اللقاء.
أحفاد
كان من دواعي سروري واعتزازي أن أكون أول الأحفاد لجدّي حامد بن عبيد بن خليف الطنيجي رحمه الله، وقابل ذلك بفرحٍ بالغٍ ومحبةٍ خاصة، تجلّت في رعايته واهتمامه بي منذ نعومة طفولتي. كان يحملني معه أينما يمم وجهه، ويخصّني بعنايةٍ لافتة، عكست عمق العلاقة التي نشأت بيننا منذ البدايات.
وأستحضر موقفاً خالداً في الذاكرة، يعبّر بصدق عن إنسانيته ومحبتِه، ففي أحد صباحات مسكننا في الزبيدة، وبينما كنت أستعد للذهاب مع والدي إلى مقرّ عمله، استوقفه جدّي وسأله عن وجهتنا فأجابه والدي بأنه متوجّه إلى المدينة لالتقاط صورة لي، بغرض التحاقي بالمدرسة.
عندها بادر جدّي، رحمه الله، إلى أخذ «قحفيته» ووضعها على رأسي، وقال لوالدي: «كيف تأخذ خليفة إلى الناس وهو لم يضع شيئاً على رأسه؟»، في تعبيرٍ بسيطٍ عميق الدلالة على حرصه واهتمامه. وهكذا التُقطت لي صورة المدرسة، وأنا أضع «قحفية» جدّي، لتبقى تلك الصورة شاهداً حيّاً على حنانه، وحضورِه الدائم في تفاصيل حياتي الأولى.
ومازالت في ذاكرتي مشاهد خيوط الفجر الأولى، وصوت سعال جدّي يسبق الضوء، يوقظ الأفق وهو يمضي إلى الوضوء استعداداً للصلاة. ونحن، بصمت الصباح، نرتدي ملابسنا ونضمّ أقلامنا إلى حقائبنا، فيما ذلك الصوت يتسلّل إلى قلوبنا قبل آذاننا. مشهدٌ عابرٌ في أيامه، خالدٌ في الذاكرة، لم يخطر ببالي يوماً أن ذلك الصوت سوف يصمت إلى الأبد.
عندما رحل جدّي حامد بن عبيد الطنيجي عام 1977، كان رحيله فاجعةً تركت وجعاً وألماً عميقين في قلبي. رغم طفولتي آنذاك وعدم إدراكي الكامل لمعنى الموت، فإن مشاهد الرحيل كانت حاضرة، رأيته مسجّى في سيارة لاندروفر، مغطّى ب «البرنوص» الذي طالما التحف به، وتشاركت معه المكان والزمان، في مشهدٍ مؤثرٍ لا يُمحى من الذاكرة، ووفاءً لذلك الجد، واستحضاراً لسيرته وما جسّده من حنانٍ ونُبل، أطلقتُ اسمه على ابني البِكر، ليظل حاضراً بيننا، ممتداً من جيلٍ إلى جيل، وحكايةً لا يغيب صداها عن الذاكرة.
غير أنّه مضى إلى رحمة ربٍّ غفورٍ رحيم، وقد سبقته إلى ربٍّ كريم جدّتي ميثا بسنوات، تلك السيدة الفاضلة التي لم نرها ولم ترَنا، ولم نتعرف إليها في الدنيا، لكنّ حضورها بقي حيّاً في الحكايات والدعاء، نسأل الله أن يغفر لهما، وأن يجمعهما ويجمعنا في جنّات النعيم، وأن تبقى ذكراهما نوراً مقيماً في القلوب والذاكرة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.