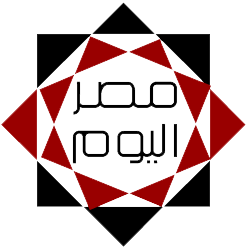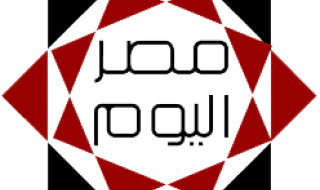يُعدّ التحوّل الديموغرافي أحد أبرز القوى التي تُشكّل العالم في القرن الحادي والعشرين. فشيخوخة السكان في أوروبا وشرق آسيا، ووفرة الفئات الشابة في إفريقيا والشرق الأوسط، وتراجع معدلات الخصوبة في الاقتصادات المتقدمة، إلى جانب موجات الهجرة غير المسبوقة، جميعها عوامل أعادت رسم الخريطة السكانية العالمية. غير أن الخطاب السائد غالباً ما يتعامل مع هذه التحولات بوصفها أزمات: أنظمة تقاعد مهدَّدة، وفرص توظيف تحت الضغط، وتماسك اجتماعي على المحك، وكأن الديموغرافيا قدرٌ ثقيل لا فكاك منه.
لكن التاريخ، كما الواقع المعاصر، يقدّم قراءة مختلفة، فالتحوّل الديموغرافي لم يكن في يوم من الأيام مجرّد عبء، بل كان في كثير من الأحيان محرّكاً للتجدد الثقافي، ومصدراً للابتكار، وأساساً لتعزيز صمود المجتمعات. ليست المشكلة في التغيّر السكاني
في حد ذاته، بل في الكيفية التي تختار بها المجتمعات ومؤسساتها التعامل معه.
تنطلق النظرة السلبية للتحوّل الديموغرافي من فهم ضيّق للقيمة الاجتماعية، فالمجتمعات المتقدمة تميل إلى اختزال كبار السن في أرقام إنفاق ومعاشات، بينما يُنظر إلى المهاجرين بوصفهم منافسين على الوظائف والخدمات، وإلى الشباب ككتلة قابلة للاضطراب. في هذه المقاربة، يُقاس الإنسان بعبئه المالي لا بإسهامه المحتمل.
هذه السردية لا تكتفي بتشخيص المشكلة، بل تسهم في تعميقها، فعندما يُقصى كبار السن عن سوق العمل، تُهدر خبراتهم. وعندما يُهمَّش المهاجرون، تبقى مهاراتهم غير مستثمرة. وحين يُحرم الشباب فرصَ المشاركة الاقتصادية والسياسية، تتراكم مشاعر الإحباط. في كل حالة، لا يكون «العبء» ديموغرافيًا بقدر ما هو مؤسَّسِيٌّ، ناتج عن عجز الأنظمة عن التكيّف مع واقع جديد.
والحقيقة أن التغيّر السكاني هو القاعدة التاريخية لا الاستثناء، فالمجتمعات لطالما تطورت عبر الهجرة، والتحوّل في البنية العمرية، وتبدّل الأجيال. السؤال الحقيقي ليس إن كان التغيير سيحدث، بل إن كانت المؤسسات قادرة على مواكبته.
التبادل الثقافي
يُعدّ التبادل الثقافي من أكثر ثمار التحوّل الديموغرافي وضوحاً، لكنه أيضاً من أكثرها إثارةً للجدل. فالتنوع يُقدَّم أحياناً بوصفه تهديداً للهوية الوطنية، وكأن الثقافة كيان جامد يتآكل مع كل إضافة جديدة، غير أن التجربة الإنسانية تُظهر عكس ذلك: فالثقافات الحيّة هي تلك القادرة على التفاعل والامتصاص وإعادة التشكل.
وتمثل المدن الكبرى المثال الأوضح. فحواضر مثل إسطنبول، ومرسيليا، وتورونتو، ودبي، لم تُبنَ على التجانس، بل على تراكم موجات بشرية متعاقبة. كل موجة أضافت لغتها وعاداتها وفنونها، وفي الوقت نفسه تبنّت عناصر من المجتمع المضيف. والنتيجة ليست ذوبان الهوية، بل نشوء هويات مركّبة أكثر غنى وتأثيراً.
هذا التفاعل الثقافي يعزّز أيضاً قدرة المجتمعات على التكيّف. فالتعرّض لتجارب وأنماط تفكير مختلفة يوسّع أفق الأفراد والمؤسسات، ويجعلها أكثر استعداداً للتعامل مع عالم معقّد ومترابط. في هذا السياق، يصبح التنوّع الثقافي رصيداً استراتيجياً، لا تجربة اجتماعية محفوفة بالمخاطر.
غير أن التبادل الثقافي لا يحدث تلقائياً، فهو يحتاج إلى سياسات تعليمية منفتحة، ومساحات عامة تشجّع التفاعل، وإعلام يتجاوز منطق «نحن وهم». حين تتوفر هذه الشروط، يتحول التنوّع إلى تجربة مشتركة بدل أن يكون مصدراً للانقسام.
تسارع الابتكار
غالباً ما يُختزل الابتكار في التكنولوجيا، لكن جذوره أعمق من ذلك. فالابتكار هو نتاج تفاعل وجهات نظر مختلفة، والتحوّل الديموغرافي يوسّع هذا التفاعل على نحو غير مسبوق. تنوّع الأعمار، والخلفيات الثقافية، والمسارات التعليمية، يخلق بيئة خصبة للأفكار الجديدة.
يلعب التنوّع العمري دوراً حاسماً هنا، فالأجيال الشابة غالباً ما تمتلك مرونة عالية في التعامل مع التكنولوجيا والتغيرات الثقافية، بينما يحمل كبار السن معرفة تراكمية وخبرة مؤسسية. وعندما تلتقي هذه القدرات، من خلال برامج الإرشاد، وأماكن العمل متعددة الأجيال، وأنظمة التعلّم مدى الحياة، يتسارع الابتكار.
حتى المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة السكانية تمتلك فرصاً كبيرة. فالتحديات المرتبطة بطول العمر حفّزت تطوراً لافتاً في مجالات الرعاية الصحية، والتقنيات المساعدة، والتخطيط الحضري، وأنماط العمل المرنة. وما يُوصَف غالباً ب«التراجع الديموغرافي» يمكن أن يتحول، في ظل سياسات مناسبة، إلى حافز للإبداع.
أما الهجرة، فهي تضيف بُعداً آخر للابتكار. فالمهاجرون غالباً ما يشكّلون جسوراً بين الأسواق والثقافات وشبكات المعرفة. كثير من مراكز البحث والشركات الناشئة حول العالم ما كانت لتزدهر لولا تدفّق المواهب العابرة للحدود، هؤلاء لا يجلبون مهارات فحسب، بل شبكات علاقات تربط الاقتصادات المحلية بالعالم.
صمود المجتمعات
في عصر تتكاثر فيه الأزمات، من الجوائح إلى التغير المناخي والتقلبات الجيوسياسية، أصبح مفهوم الصمود المجتمعي أكثر أهمية من أي وقت مضى. الصمود لا يعني فقط قوة الاقتصاد أو متانة البنية التحتية، بل قدرة المجتمع على التماسك والتعافي.
المجتمعات المتنوعة ديموغرافياً غالباً ما تكون أكثر صموداً، لأنها أقل اعتماداً على فئة واحدة أو نموذج واحد. فالعائلات متعددة الأجيال توفر شبكات رعاية غير رسمية في أوقات الأزمات. والمجتمعات المهاجرة غالباً ما تطوّر شبكات دعم داخلية قادرة على التحرك بسرعة عند الحاجة.
والعنصر الحاسم هنا هو الاعتماد المتبادل. فعندما تُشجَّع العلاقات بين الأجيال والثقافات والطبقات الاجتماعية، تتكوّن شبكات أمان اجتماعي غير مرئية لكنها فعّالة. في المقابل، يؤدي الفصل، سواء كان عمرياً أو اقتصادياً أو ثقافياً، إلى إضعاف القدرة على مواجهة الصدمات.
البعد الاقتصادي
اقتصادياً، يفرض التحوّل الديموغرافي تحديات حقيقية على نماذج النمو التقليدية، لكنه يفتح أيضاً آفاقاً جديدة، فشيخوخة القوى العاملة وتراجع معدلات الخصوبة تثير مخاوف مشروعة حول الإنتاجية والاستدامة المالية، غير أن الحل لا يكمن في الانغلاق، بل في توسيع المشاركة.
إطالة الحياة المهنية عبر العمل المرن، ودعم مشاركة النساء في سوق العمل، ودمج المهاجرين في الاقتصاد الرسمي، كلها سياسات قادرة على تخفيف الضغوط الديموغرافية، وهي لا تزيد حجم القوى العاملة فحسب، بل تحسّن كفاءتها من خلال الاستفادة الأفضل من المهارات المتاحة.
أما المجتمعات الفتيّة، فتواجه التحدي المعاكس: استيعاب أعداد كبيرة من الشباب. وهنا أيضاً، يمكن للتحوّل الديموغرافي أن يكون فرصة، فالشباب يمثلون طاقة هائلة للريادة والابتكار الثقافي والرقمي، شرط توفير التعليم والبنية التحتية والمسارات الاقتصادية المناسبة.
قوة القيادة
تلعب السرديات دوراً حاسماً في تشكيل الاستجابة للتحوّل الديموغرافي. فالطريقة التي يتحدث بها القادة عن التغير السكاني تؤثر في السياسات والمواقف العامة. خطاب الخوف ينتج الإقصاء، بينما خطاب الفرصة يفتح الباب أمام التعاون.
لا يعني ذلك تجاهل التحديات، بل التعامل معها دون شيطنة الفئات السكانية. فإدارة الضغوط شيء، وتحويل الناس إلى «مشكلة» شيء آخر. هنا تبرز أهمية التعليم والإعلام في بناء فهم أعمق للديموغرافيا، بعيداً عن التبسيط والتهويل. وتتطلب إعادة تصور التحوّل الديموغرافي عقداً اجتماعياً جديداً يعترف بقيمة الإسهام عبر مختلف مراحل الحياة ومن مختلف الخلفيات، عقداً يثمّن العمل غير المدفوع، ويعترف بالمهارات المكتسبة خارج القنوات التقليدية، ويشجّع المشاركة المدنية والاقتصادية المستمرة.
هذا النهج لا ينكر الواقع الديموغرافي، بل يتفاعل معه بوعي، وهو يدرك أن المجتمعات ستظل في حالة تغيّر دائم، وأن قوة المؤسسات تُقاس بقدرتها على التكيّف.
قوة لا مفر منها
التحوّل الديموغرافي حتمي. أما نتائجه فليست كذلك. فحين يُعامَل بوصفه عبئاً، يصبح مصدر خوف وانقسام، وحين يُنظر إليه كقوة كامنة، يتحول إلى محرّك للتبادل الثقافي والابتكار وصمود المجتمعات.
الاختيار ليس بين الاستقرار والتغيير، بل بين رد الفعل والانخراط الواعي. والمجتمعات التي تحسن استثمار التحوّل الديموغرافي لن تكتفي بالتكيّف مع المستقبل، بل ستسهم في صناعته.
دبي تحوله إلى مصدر قوة وتضم 200 جنسية
تُعدّ دبي مثالاً معاصراً واضحاًَ على كيفية جَعْل التحوّل الديموغرافي مصدر قوة، فالإمارة تضم أكثر من مئتي جنسية، ومع ذلك لم يؤدّ هذا التنوع إلى تفكك اجتماعي، بل أدى إلى نشوء ثقافة حضرية هجينة قائمة على الانفتاح والكفاءة الاقتصادية. أسهم هذا الواقع السكاني في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والابتكار، حيث تعمل الكفاءات القادمة من آسيا وأوروبا والعالم العربي جنباً إلى جنب ضمن إطار قانوني ومؤسسي واحد. هنا، لم يُنظر إلى التنوّع السكاني كتهديد للهوية، بل كشرط من شروط الاندماج في الاقتصاد العالمي.
في المقابل، تمثل اليابان حالة مختلفة ولكنها لا تقل دلالة، فمع كونها واحدة من أكثر الدول شيخوخة في العالم، واجهتْ تحديات حادة في سوق العمل والرعاية الاجتماعية، غير أن هذه التحديات أصبحت دافعاً للابتكار، لاسيما في مجالات الروبوتات، والرعاية الصحية الذكية، والتقنيات المساعدة لكبار السن، لقد دفع التحوّل الديموغرافي الدولة والشركات إلى إعادة التفكير في الإنتاجية والعمل والرعاية، ما جعل اليابان مختبراً عالمياً لحلول ستحتاجها دول أخرى عاجلاً أم آجلاً.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.